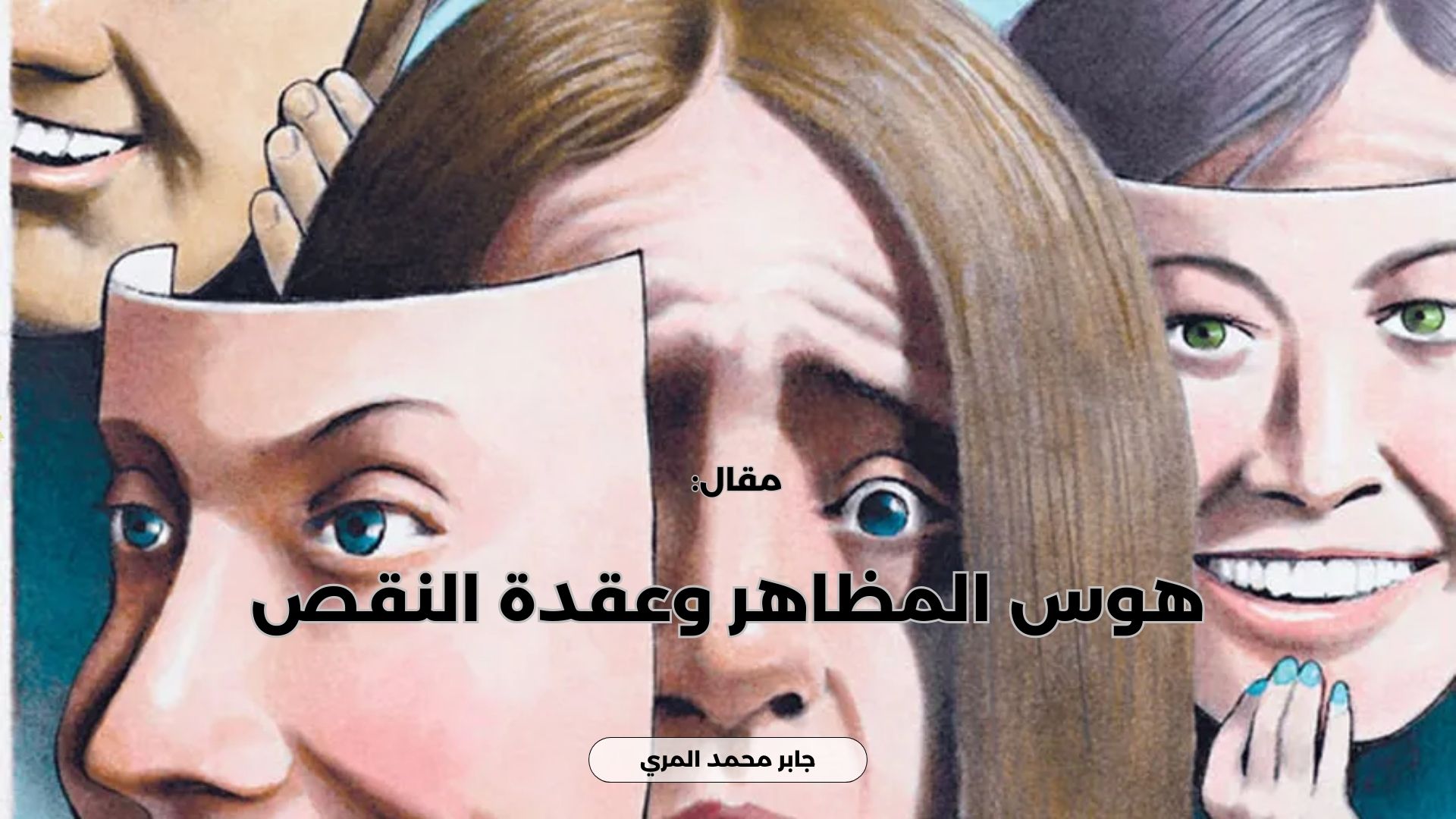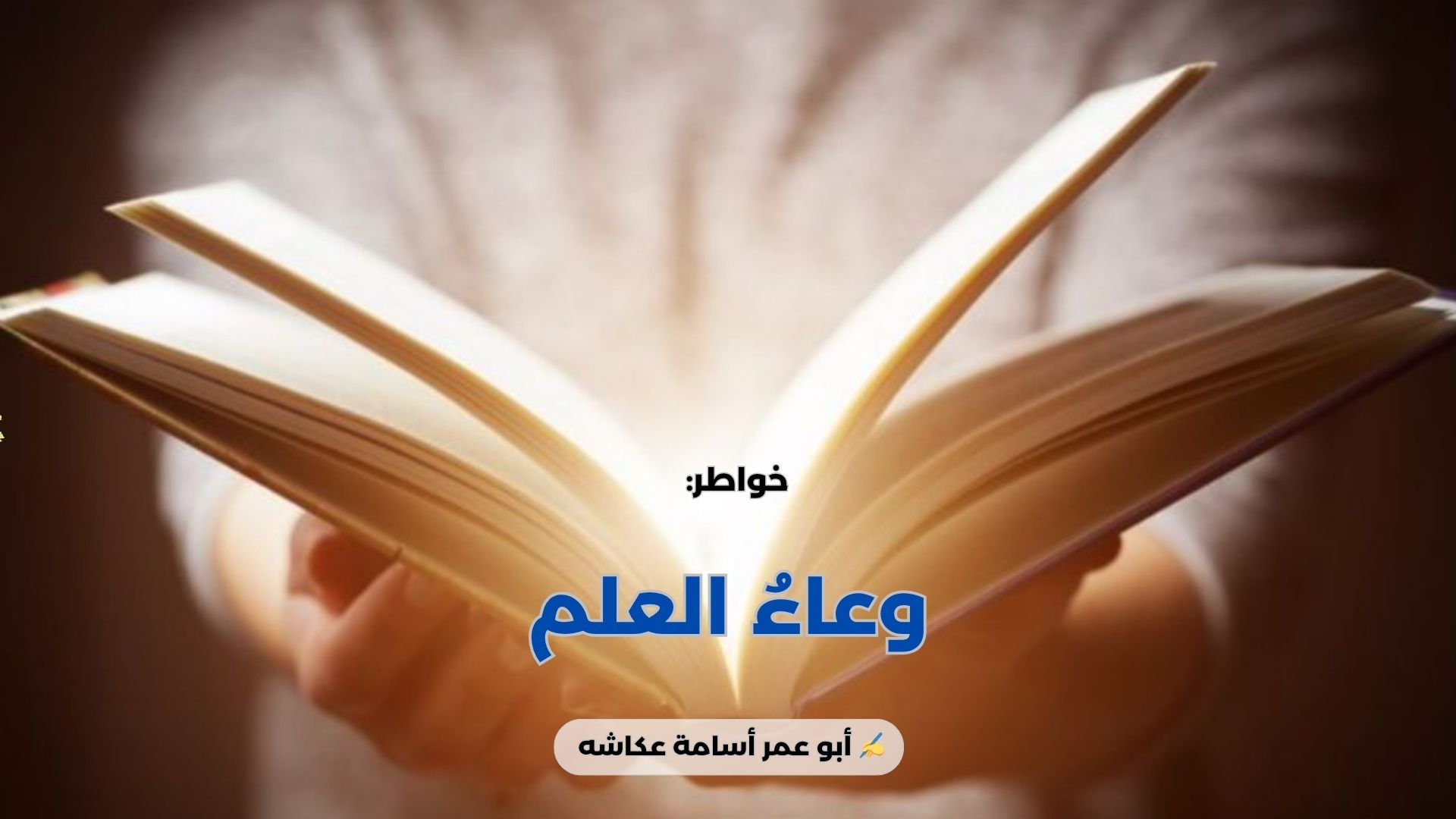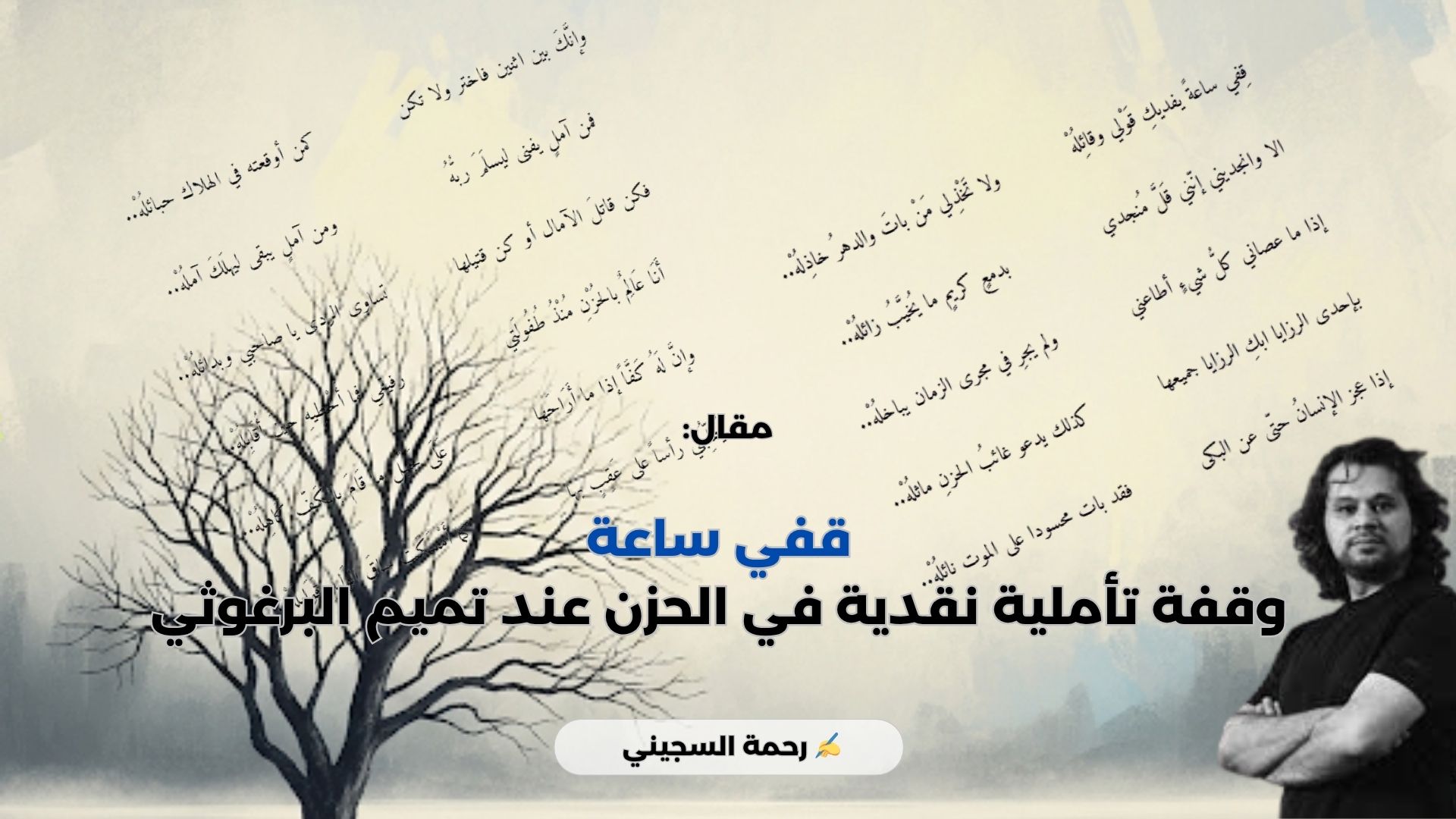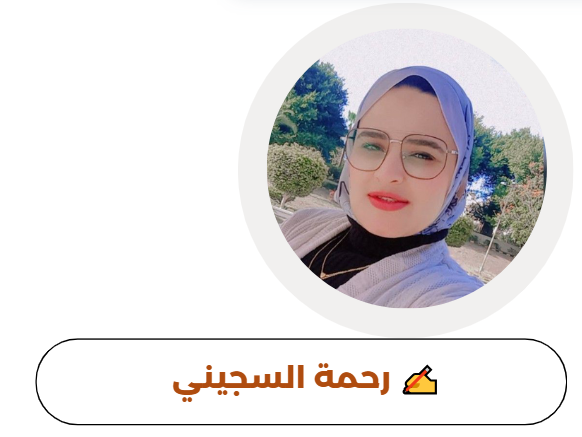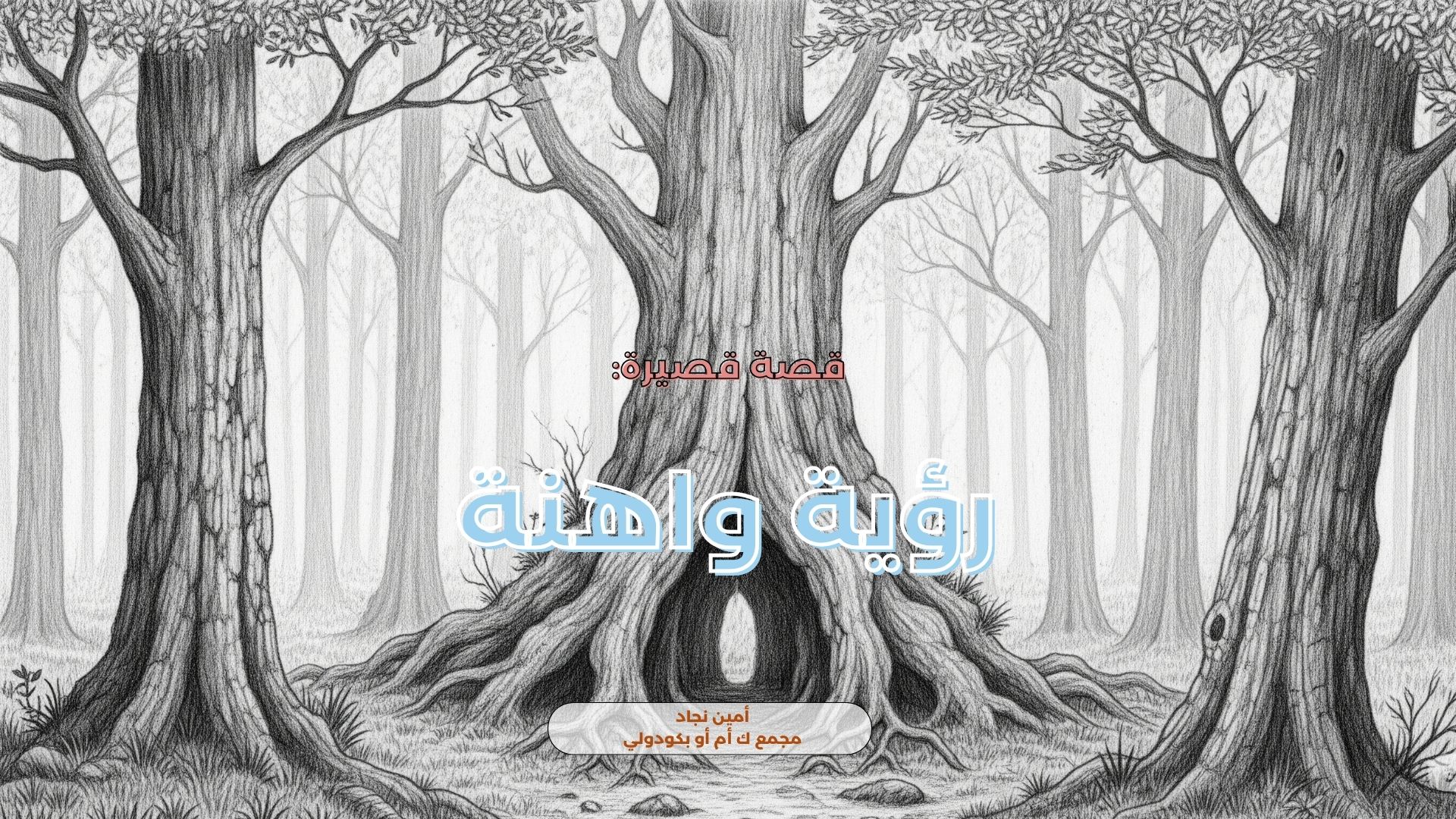هوس المظاهر وعقدة النقص
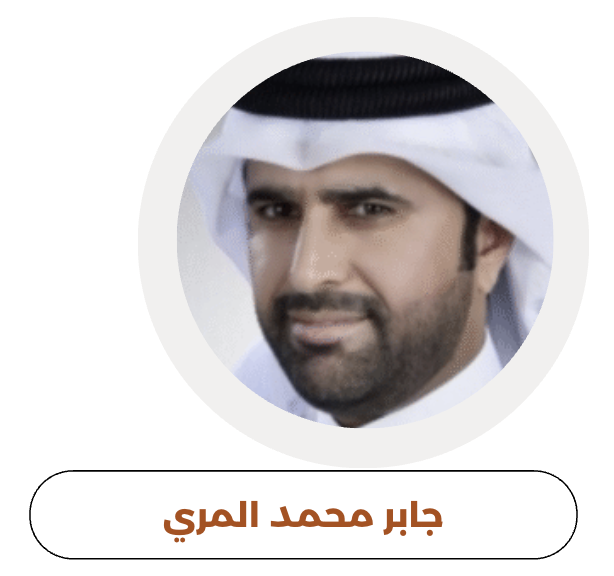
من المؤلم أن نرى أبناء خير أمة أخرجت للناس يتسابقون في التفاخر والتباهي بما يملكونه من سيارات ويخوت وساعات وحقائب وذهب وكل ما يشد العين والقلب، وخاصة في سفراتهم وجولاتهم في العديد من العواصم العالمية، ولو كانوا يحتفظون ببذخهم ورفاهيتهم لأنفسهم لاحترمنا عقولهم وإدراكهم ولكن الكثير منهم من المتباهين والمتفاخرين يوثقون سفراتهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي منذ دخولهم قاعة الدرجة الأولى وهم يرتدون أغلى الملابس والساعات والحقائب من الماركات العالمية، وعند ركوبهم مقصورة الدرجة الأولى أو رجال الأعمال، وصولاً إلى وصولهم إلى وجهتهم التي يحرصون أن تكون في أغلى الوجهات من حيث أسعار الفنادق والمطاعم والسيارات الفارهة، ليبدأ حينها في رفع نسبة التفاخر والتباهي بما يملكه ويغمره شعور عظيم بأنه ليس هناك في الأرض من هو أعظم ولا «أكشخ» منه، فيمشي في الأرض مرحاً ظناً منه أن الإكبار والإعجاب لا يأتي إلا باستعراض المظاهر والهيئة وبهالة من الغرور والتفاخر.
شخّص أحد الاستشاريين النفسيين هذه الحالة بأنه (اضطراب نفسي) يُعرف علمياً باسم هوس المظاهر أو الهوس بالمكانة الاجتماعية (Status Anxiety).
وذلك عبر الاستعراض وهو نمط سلوكي يتسم بانشغال مفرط في عرض مظاهر الرفاهية أو الثراء أو النجاح أمام الآخرين، وذلك غالباً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على الإعجاب أو الاعتراف الاجتماعي، حتى لو كان ذلك على حساب الواقع المالي أو النفسي للفرد.
ويوضح هذا الاستشاري بأن الأعراض أو المؤشرات التي قد تظهر على الشخص الذي يعاني من هوس إبراز المكانة الاجتماعية عبر الاستعراض تختلف بحسب شدة الحالة، لكنها غالباً تكون على شكل سلوكيات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مستمر لصور وفيديوهات تُظهر السفر، الفنادق الفاخرة، المطاعم الراقية، المشتريات الباهظة، والتركيز على إظهار العلامات التجارية الفاخرة أو تفاصيل الدرجة الأولى في السفر، والتقاط الصور بشكل متعمد في أماكن أو أوضاع تدل على الثراء أو المكانة الاجتماعية.
كما أن للدوافع الداخلية للشخص دورا كبيرا في هذه الحالة من خلال الشعور بالرضا أو القيمة الذاتية فقط عند الحصول على إعجاب أو تعليقات إيجابية من الآخرين، وحالة من القلق أو الانزعاج إذا لم تلقَ هذه المنشورات التفاعل المتوقع، والسعي للمقارنة مع الآخرين ومحاولة التفوق عليهم في المظاهر.
ويرى الاستشاري النفسي أن أنماط تفكير هذه النوعية من البشر تتمحور في عدة أمور؛ بدءًا من اعتقادهم وقناعتهم التامة بأن المكانة الاجتماعية تعتمد أساساً على المظاهر المادية، ثم المبالغة في أهمية رأي الآخرين والانشغال الدائم بكيفية نظرتهم إليهم، وقياس النجاح الشخصي بما يمتلكونه أو يعرضونه لا بما يحققونه فعلياً. أما التأثيرات السلبية المحتملة على هذه العينة فقد لخصها في ثلاثة جوانب؛ مالياً من خلال إنفاق مبالغ كبيرة أو فوق القدرة المالية للحفاظ على الصورة التي يريد إظهارها، ونفسياً عندما يشعر دائماً بعدم الاكتفاء أو الخوف من فقدان الانبهار من الآخرين، واجتماعياً من خلال بناء علاقات سطحية قائمة على الانطباع الخارجي بدلاً من الحقيقي.
ومن وجهة نظره العلمية النفسية يرى بأنه لا علاج لهذه العينة إلا من خلال إخضاعهم لبرامج وقائية ونفسية تبدأ من الوعي الذاتي والتثقيف النفسي بمساعدتهم على إدراك أن قيمتهم ليست مرتبطة بالمظاهر أو بآراء الآخرين، وتوعيتهم بمخاطر الإنفاق المفرط لمجاراة صورة اجتماعية معينة، وأيضا العلاج المعرفي السلوكي من خلال تعديل الأفكار المشوهة حول النجاح والمكانة الاجتماعية، وتأتي باستبدال السلوكيات الاستعراضية بسلوكيات مبنية على القيم الحقيقية والإنجازات الواقعية، أو بالعلاج النفسي العميق والذي يُقصد به أنه إذا كان الهوس بالمظاهر مرتبطاً بجروح نفسية قديمة (مثل نقص القبول في الطفولة أو الشعور بالدونية).
ومن ضمن البرامج الوقائية تقليل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضع أوقات محددة لاستخدام المنصات الاجتماعية، والتوقف المؤقت عن نشر المحتوى الذي يهدف فقط لإبراز المظاهر، واستبدالها بمتابعة حسابات ملهمة تركز على نشر القيم أو الإنجازات الفعلية. عند تحقيق أهداف هذه البرامج الوقائية سيصل الشخص إلى مرحلة إعادة مفهوم النجاح من خلال التركيز على المهارات والعلاقات الحقيقية والإنجازات العملية بدلاً من إبرازه للمظاهر، وتحديد أهداف شخصية ومهنية لا تعتمد على رضا الجمهور، وكل ما سبق من برامج وقائية لا شك بأنها تحتاج إلى دعم اجتماعي من خلال إحاطة النفس بأشخاص يُقدّرون الجوهر ويتجاهلون المظاهر الزائلة، ويترجمونها من خلال المشاركة في الهوايات والأنشطة التي لا يمكن قياسها بالمكانة المادية مثل (التطوع، التعلم، الرياضة). خلاصة هذه الدراسة تتلخص بحقيقة جلية تؤكد بأن هذه العينة التي زادت أعدادها كثيراً في وقتنا الحاضر ليسوا إلا مرضى نفسيين يعانون من (عقدة النقص) يُعظمون أنفسهم وهم في نظر المجتمع ليس لهم أي قيمة.