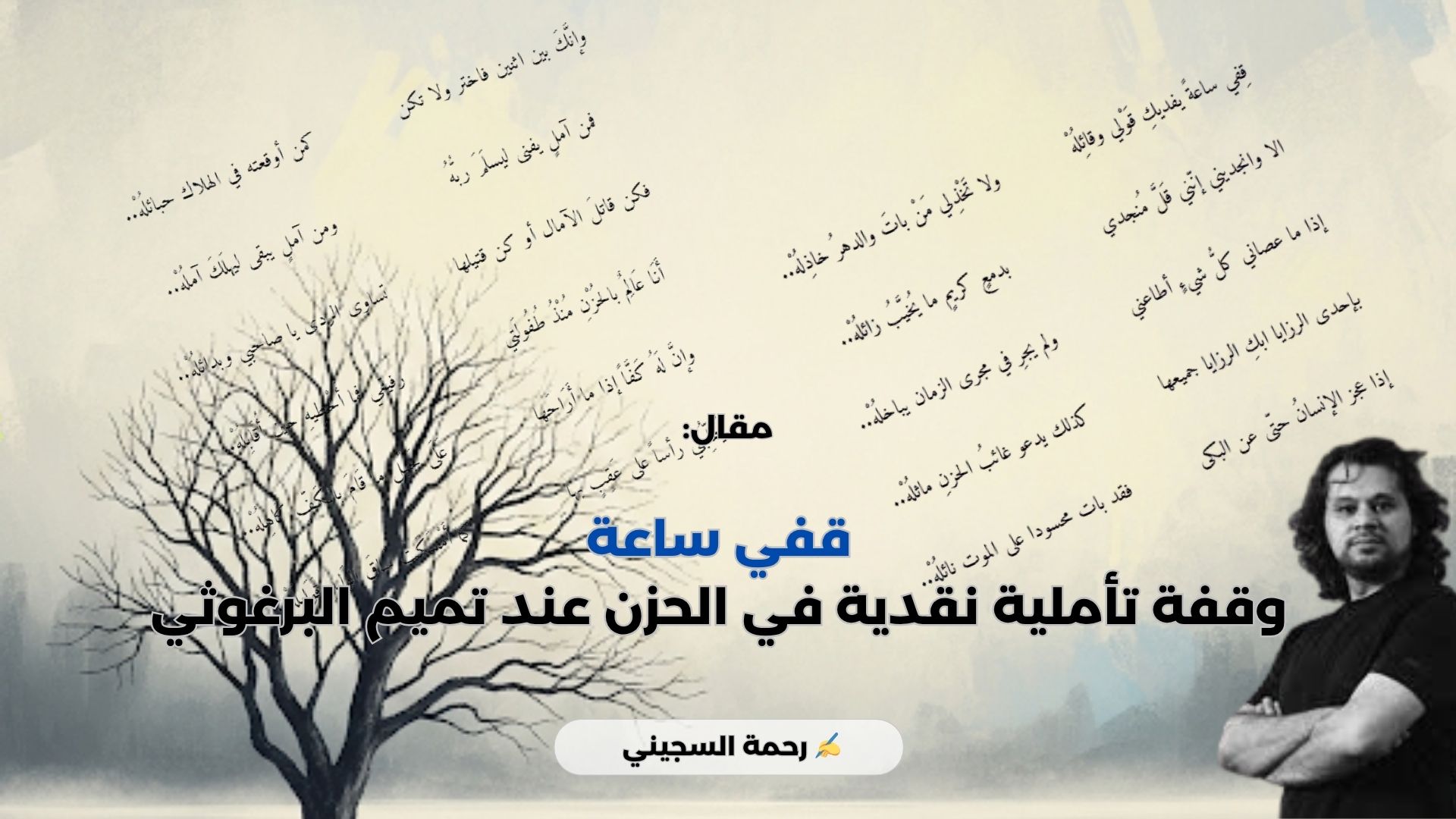قفي ساعة: وقفة تأملية نقدية في الحزن عند تميم البرغوثي
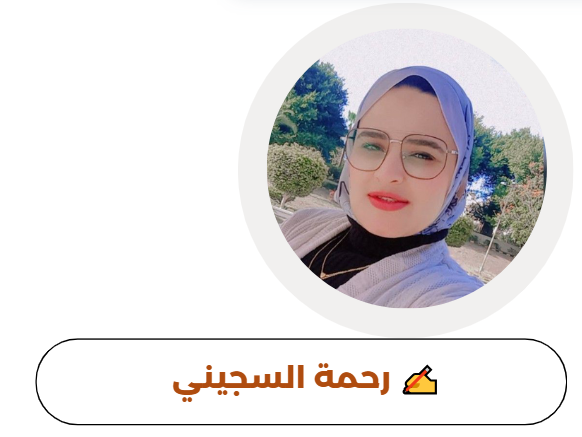
لتميم البرغوثي أبيات تجسد صراعا داخليا بين شاعر مرهف الإحساس، وحزن له سطوة المقاتل الشرس، وهذه الأبيات من أبياته الأثيرة عندي، ولذلك آثرت الوقوف معها قليلا وتأملها، اقتبستها من قصيدته (قفي ساعة) التي خلد فيها قصة ( الطفل الشهيد محمد جمال الدرة) عليه رحمة الله، والحزن عند تميم ليس مجرد حزن ذاتي، بل هو حزن أمة، وله جذور سياسية/ وجدانية، مما يعطي طابعا كونيًا لهذا (الحزن الرفيق).
تستهل القصيدة باستيقاف المتلقي، على عادة العرب قديما في معلقاتهم، وكأنها تشكل حالة من الأصالة، كما تشكل امتدادا للجذور، وكأن الشاعر يريد من البداية أن يلفت انتباه المستمعين إلى أهمية الخطاب الذي سيتلوه على مسامعهم، فهو يوجه خطابا شخصيا مباشرا بصيغة طلبية للمؤنث في قوله:
قِفي ساعةً يفديكِ قَوْلي وقائِلُهْ ..
ولا تَخْذِلي مَنْ باتَ والدهرُ خاذِلُهْ..
حيث يبدأ الخطاب بطلب إنشائي ودعوة رقيقة للاستماع إلى شجون أليمة، عبر عنه صيغة الفعل الأمر المتصل بياء المخاطبة المؤنثة في قوله (قفي) محددا مهلة الخطاب بلفظة (ساعة)؛ بغرض الإفصاح عن بعض الأمور الهامة (من الهم) والمهمة (من الأهمية) مما يثقل قلب لشاعر ويستدعي الإنصات، ثم يتبع الشاعر الطلب الأول بطلب آخر جاء في صورة الدعاء ( يفديك قولي وقائله)، لإضفاء مزيد من التوسل والاستعطاف.
وفي النص نداء مضمر إلى هذه السيدة التي يدعوها الشاعر للتوقف وتبادل الحديث معه، لعلها إن سمعته أن تخفف بعض شجونه التي لا يستطيع غيرها أن يخففها، ولا ينفك الشاعر يستخدم الاساليب الطلبية في تمرير رسالته المحملة بشحنات من الرجاء في قبول الدعوة وعدم التخلي عنه في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى أذن مصغية تحمل عنه همومه.
يهدف هذا التنوع الأسلوبي إلى استمالة المخاطبة المقصودة، ومن ذلك قوله ( ولا تخذلي من بات والدهر خاذله)، إذ إن فيها دعوة حقيقية وادعاء صادق على خذلان الدهر للشاعر؛ فحين تجتمع الهموم وتجثم على القلب يبحث المرء عمن يستمع إليه ويخفف عنه، لكن يبدو من الخطاب أن الشاعر يستميل امرأة معرضة، لا تشغلها همومه ولا تعنيها، ولذلك نراه يلجأ للتنوع الأسلوبي في عرض شكواه وشجونه.
ولكن تُرى من تكون هذه المرأة؟ ولماذا يبذل الشاعر جهده كي يُسمعها؟ هذا ما لم يخبرنا به الشاعر، بل ترك للمتلقي حرية التأويل، وإن كنت أرى أن الشاعر يخاطب (الأمة المُعْرِضَة) لتقف وتعي ما يحدث حولها، لعلها تفيق من غفلتها، قبل أن يفوت أوان النجاة.
تأتي لفظة (الدهر) في موضعها معرفة بأل، للدلالة على ترصد الدهر لهذا الشاعر، واجتماعه على خذلانه، وليصف الشاعر عمق شعوره بالخذلان، لم يخذله فرد أو شخص، بل دهر لا يعرف سوى الخذلان المقيت.
تبرز ملامح الحزن وترتسم في قصيدة (قفي ساعة) في مقطع شعري متماسك يتكون من خمسة أبيات متتالية، يتمثل فيها الحزن للشاعر رفيقا معلومًا، تتصاعد سطوته تدريجيا حتى تبلغ ذروتها فتتكشف حقيقته المقيتة، إذ يتمثل له كيانا مرعبًا يتحكم في حياته وموته، وإذا تتبعنا (الحزن) من بداية نص القصيدة، نطالعه في البيت الرابع منها في قوله:
بإحدى الرزايا ابكِ الرزايا جميعها ..
كذلك يدعو غائبُ الحزنِ ماثلُهْ..
في مقدور مصيبة واحدة أن تشعل نيران حزن لا يطفئها البكاء، فهي كفيلة بأن توقظ في قلبك كل الأحزان التي مرت، فإذا حضر الحزن استدعي كل حزن غابر، لتتمثل أمامك أحزانك حزنًا واحدا، فكما أن الحزن الحاضر يوقظ الحزن الغائب، كذلك رزية واحدة قد تستدعي وتوقظ كل ما كان قبلها من رزايا وأوجاع.
يبرز الحزن في هذا البيت في صورة الداعي الذي إن حضر وجبت دعوة الغائبين للقائه والمثول في حضرته، وهي استعارة تشخصن الحزن وتجعل له سلطانا وهيمنة وهيبة، والحزن لا ينفصل عن الرزايا، فهو قرينها، فمتى جاءت الرزايا، حضر الحزن لاستقبالها والبكاء عليها.
ويلاحظ ورود الحزن (فردًا) إلا أن الرزايا وردت فردًا وجمعًا، وهذه مقابلة لافتة، إذ يلتقي الحزن الفرد مع الرزايا جميعها للبكاء عليها، وهذا مبالغة في قدرة الحزن واحتوائه على فرادته للمصائب وإن كانت جمعًا، وفي البيت تشبيه للمصيبة وهي تستدعي أخواتها من الرزايا كما يستدعي الحزن ماضيه.
هذا الحزن وإن بدا ذاتيا في ظاهره، إلا إنه يشير في عمقه إلى حزن جماعي سياسي/ إنساني، فالرزايا التي تستدعي بعضها لا تقتصر على آلام شخصية، وإنما تتسع لتشمل رزايا أمة تعيش الهزيمة تلو الأخرى، مما يجعل من الحزن في هذا الموضع حزنًا كونيا، ذا طابع جمعي يتجاوز حدود الذات إلى آفاق الأمة.
ينتقل الشاعر في البيت التاسع من القصيدة ليباغت المتلقي بإعلان مباشر أفصح فيه عن ارتباطه القديم بالحزن ارتباط جعله قادرا على استشراف ما قد يصيبه لاحقا، نتيجة لهذه المعرفة العميقة بالحزن، وتتجلى مظاهر هذا الوعي في استخدامه صيغة اسم الفاعل (عالم) في قوله:
أَنَا عَالِمٌ بالحُزْنِ مُنْذُ طُفُولَتي ..
رفيقي فما أُخْطِيهِ حينَ أُقَابِلُهْ..
مشيرًا إلى أن الحزن لم يكن وليد لحظة عابرة، أو موقفا منسيا في ذاكرته، بل حزن أزلي نشأ معه في طفولته وصاحبه بقية حياته واستمر معه حتى بات جزءا لا ينفصل عن مصيره.
حتى إن غاب هذا الحزن الصاحب (الرفيق) ساعة، فإن الشاعر لا يخطئه حين يلقاه، ويتضح هذا المعنى في نفيه للفعل المضارع (فما أخطيه) إلى جانب تخفيف الهمزة في لفظة (أخطئه)، مما يوحي بسهولة التعرف عليه، ويضفي على علاقتهما طابع الألفة المعتادة، كما تؤكد لفظة (حين) ديمومة اللقاء بينهما، وكأن الحزن ضيف دائم بلا موعد مسبق.
وتتجلى في هذا البيت ملامح الاستعارة حين يصور الحزن الذي يلقاه على هيئة رفيق قديم لا يُنسى، مهما طال الفراق، فقد استطاع هذا الحزن أن يحتفظ بملامحه القاسية وهيبته، مما يمكن الشاعر من تمييزه كلما شعر بقربه، فحين استعار له الرفقة واللقاء، تجسد الحزن في هيئة صديق لدود، فرض حضوره مرارا بقسوة، يعرفها الشاعر حق المعرفة.
يسترسل تميم بعد ذلك وصفه لذلك الرفيق القاسي، قائلا:
وإنَّ لَهُ كَفَّاً إذا ما أَرَاحَها..
عَلَى جَبَلٍ ما قَامَ بالكَفِّ كَاهِلُهْ..
ويلاحظ هيمنة أسلوب الشرط على وصف الحزن في هذا البيت إذ تنشأ عنه صورة ترتسم فيها ملامح القسوة والقوة المرعبة الكامنة في الحزن، وقد ورد الشرط في البيت بأداته ( إذا) وفعله (أراح) المسبوق بما الزائدة لتوكيد المعنى، وفعل الجواب (قام) المسبوق بما النافية لنفي قدرة الجبل على تحمل الكف، مما يدعم القوة الخارقة للحزن، وكأنه مخلوق أو كيان أسطوري.
وتكرار الحرف (ما) في البيت لم يرد اعتباطا، بل ورد ليضفي نغمة موسيقية ثقيلة تتناسب مع ثقل الكف وثقل المعنى، ويفيد التكرار توكيد المعنى وإحكامه، فوجود (ما) مرتين يبرز التحول الدرامي من وضع الكف بهدوء إلى انهيار الجبل.
نكرت (كف) تعظيما لسطوتها، فهي ليست كفا عاديا، بل كف تتفوق على التصور، بينما وردت كلمة (جبل) نكرة للدلالة على العموم أو التهويل، بمعنى أن أي جبل مهما بلغت ضخامته وقوته لا يستطيع الصمود أمام هذا الكف، ويفهم من هذا أن الحزن يمتلك قدرة مدمرة، لأن مجرد ملامسة الكف للجبل تهدمه، فما بالنا لو ضربه أو ضغط عليه؟ فالتنكير هنا يخدم المبالغة في التصوير البلاغي للقوة.
وتتضح ملامح الاستعارة أكثر حين يتجسد الحزن كيانا قاسيا ثقيلا، فإذا كان الجبل لا يصمد أمام هذا الكف الرهيب، فكيف بقلب شاعر نحيل، يلتقي بالحزن كل حين؟
ينتقل الشعر إلى البيت التالي مصورا تصرفات الحزن ذو الكف المخيف معه، في قوله:
يُقَلِّبُني رأساً على عَقِبٍ بها..
كما أَمْسَكَتْ سَاقَ الوَلِيدِ قَوَابِلُهْ..
حيث يبالغ الشاعر في وصف أفعال رفيقه الحزن به، حين يقابله، ويبدو أن لقاء الحزن الرفيق من أقسى لقاءات الشاعر، إذ تنفي أفعاله القاسية بالشاعر صحبته الطيبة، فإذا كانت المفردتان (عالم، رفيقي) يشيران إلى ألفة واستئناس، فإن هذا البيت يكشف عن الوجه الآخر لهذا الرفيق، وجه الجبروت والقسوة، إذ نراه يقلب الشاعر رأسا على عقب، لا قلبًا للوجدان فحسب، بل تمزيقًا لكيانه كله.
ويعبر عن ذلك الفعل المضارع الذي استهل به البيت مع شدة على اللام ( يقلِّبني) لإظهار المبالغة في سلطة الحزن وسطوته إذ يكون الشاعر في يده كالوليد في يد القابلة، حين تقلبه وتمسكه من ساق واحدة فينقلب رأسه لأسفل، إلا أن الحزن لا يقلب الشاعر رأسا على عقب فقط بل يقلِّبه أي يتحكم فيه بعدما يفقده قدرته على المقاومة والتحكم بنفسه؛ ولذلك وردت كلمة (ساق) مفردة للدلالة على أن الشاعر يترنح في مخالب الحزن غير متزن كما يترنح الوليد الذي أمسكت به القابلة من ساق واحد.
ويلاحظ استعانة الشاعر بالتشبيه لتكتمل الصورة، فكأنه أراد أن يقول إن الحزن لديه من الوعي بما يفعل ما لدى القابلة من وعي بما تفعله بالوليد، أما الشاعر أمام هذا المخلوق المتجبر مسلوب الإرادة رغم وعيه الكامل بما يحدث ..
كما وردت كلمة (قوابل) جمع للدلالة على الفرحة بميلاد الوليد بينما يُحدث هذا الجمع مفارقة بين حال الوليد الذي يتأرجح في يد القوابل استعدادا للحياة، وحال الشاعر الذي يترنح في يد الحزن ليواجه الهلاك والموت، فشتان ما بين الوليد المرتجي حياته في يد القوابل، والشاعر المرتجي موته في كف الحزن، فكأن الشاعر لا يولد في الحزن، بل يسحب إليه كما يسحب جسد إلى مهلكه.
وكأن الحزن لم يعد طارئا على الشاعر، بل أحد مكونات وعيه وذاته، يتحكم به كما تتحكم الذاكرة القديمة في ردود أفعالنا الحديثة.
يتابع الشاعر تصوير عبث (الحزن) به قائلا:
وَيَحْمِلُني كالصَّقْرِ يَحْمِلُ صَيْدَهُ..
وَيَعْلُو به فَوْقَ السَّحابِ يُطَاوِلُهْ..
يستمر الشاعر في تصوير حالته بين يدي الحزن المقيت، معتمدا على الفعل المضارع (يحمل، يعلو، يطاول)؛ للدلالة على استمرارية سطوة الحزن، وتوالي التشبيهات باستخدام الأداة (الكاف) ليصنع صورة جديدة أكثر عمقا وتأثيرا، إذ يشبه الحزن بصقر جارح مفزع يحمل الشاعر كما يحمل فريسته بعدما تمكن منها، ويطير به بعيدا متجاوزا حدود النظر؛ ليختلي به فوق السحاب ويتلذذ بافتراسه وحيدًا، فنرى الشاعر بعدما فقد كل قوته، وأصبح حملا هالكا بين مخالب الصقر يعلو معه إلى وكره هناك فوق السحاب، وهو تشبيه تمثيلي، وفي قوله (يطاوله) دلالة على شدة البعد المقصود.
وفي قوله: ( ويحملني كالصقر يحمل صيده)، استعارة ضمنية ممتدة( الصقر= الحزن، الصيد= الشاعر، لكن لم يصرح بهما).
نستطيع القول إذن إن الحزن لا يفعل ما يفعل عبثا، بل بسبق إصرار، كمن يعرف أين يؤلم ضحيته أكثر، فالحزن (الصقر) يتعمد أفعاله بالشاعر (الصيد) ويقصد الاختباء به في أبعد مكان، حيث لا يدع للشاعر فرصة يتوسل بأحد أو ينجو بنفسه منه، ما يعكس شعور الشاعر بالعزلة المرعبة تحت سطوة الألم.
فإنْ فَرَّ مِنْ مِخْلابِهِ طاحَ هَالِكاً..
وإن ظَلَّ في مِخْلابِهِ فَهْوَ آكِلُهْ..
يختتم الشاعر هذا المقطع بصوت تأملي عميق عبر عنها أسلوب الشرط بأداته (إن) المقترن بالفاء، وفعليه ( فر، طاح) ويتلوه شرط آخر تتكرر فيه الأداة (إن) وفعلها (ظل) مسبوقة بواو العطف التي ورد ذكرها دلالة على حتمية الهلاك رغم تعدد احتمالات الهروب، كما يلاحظ استبدال اسم الفاعل(آكله) بفعل جواب الشرط، فحمل الجواب معنى المفعولية والقسوة في آن واحد، وفي البيت انزياح معنوي يجعل من الحزن فاعلا يتلبس صفات الوحش المفترس، لا مجرد انفعال داخلي.
وتؤكد هيمنة الشرط في هذا البيت على وعي الفريسة بما يحدث لها، مع استحالة القدرة على التصرف ورد الفعل، فالشرط الأول نهايته الهلاك، ولا تختلف نهاية الشرط في الشطر الثاني كثيرا عن نهايته في الشطر الأول، بل إنها هنا حتمية ومؤكدة باسم الفاعل (آكل)، فسواء فر الشاعر من قبضة الحزن، لن تتركه تبعات هذا الحزن وهو هالك لا محالة، وسواء ظل تحت تأثيره فهو آكله أيضا بلا شك ..
في الختام أتساءل كيف يستطيع المرء أن يتقبل في حياته مجرما بل قاتلا متسلسلا كالحزن؟ الحزن لا يكتفي بكبت المشاعر، بل يهاجم النفس ويجثم على القلب ويزهق الروح، وهو بذلك يتخطى كونه شعورا ثقيلا، ليصبح قاتلا مشهورا ما لأحد من سلطان عليه وهذا ما يريد أن يثبته الشاعر من بداية المقطع .