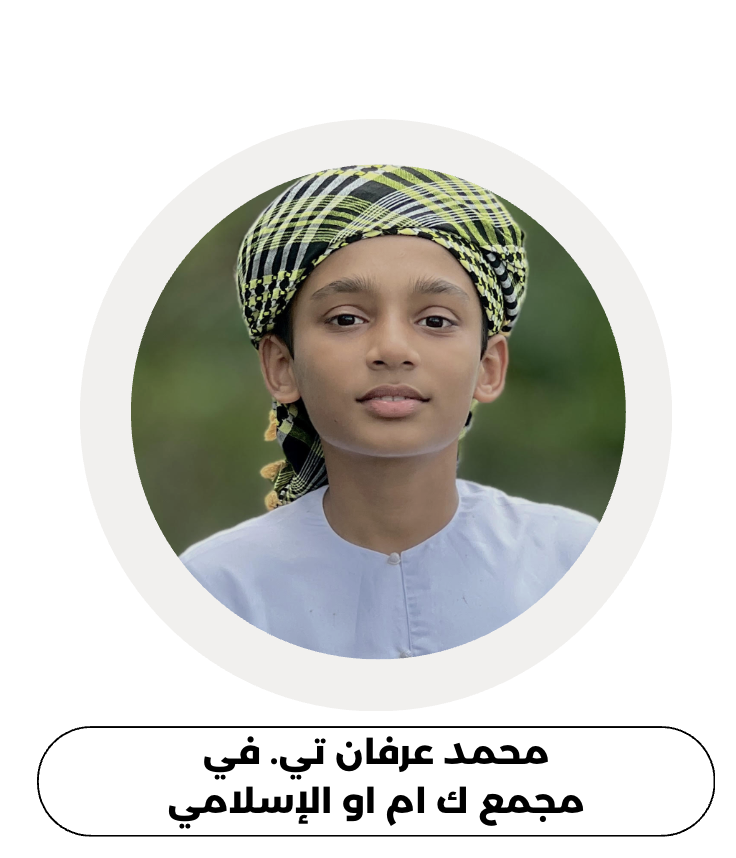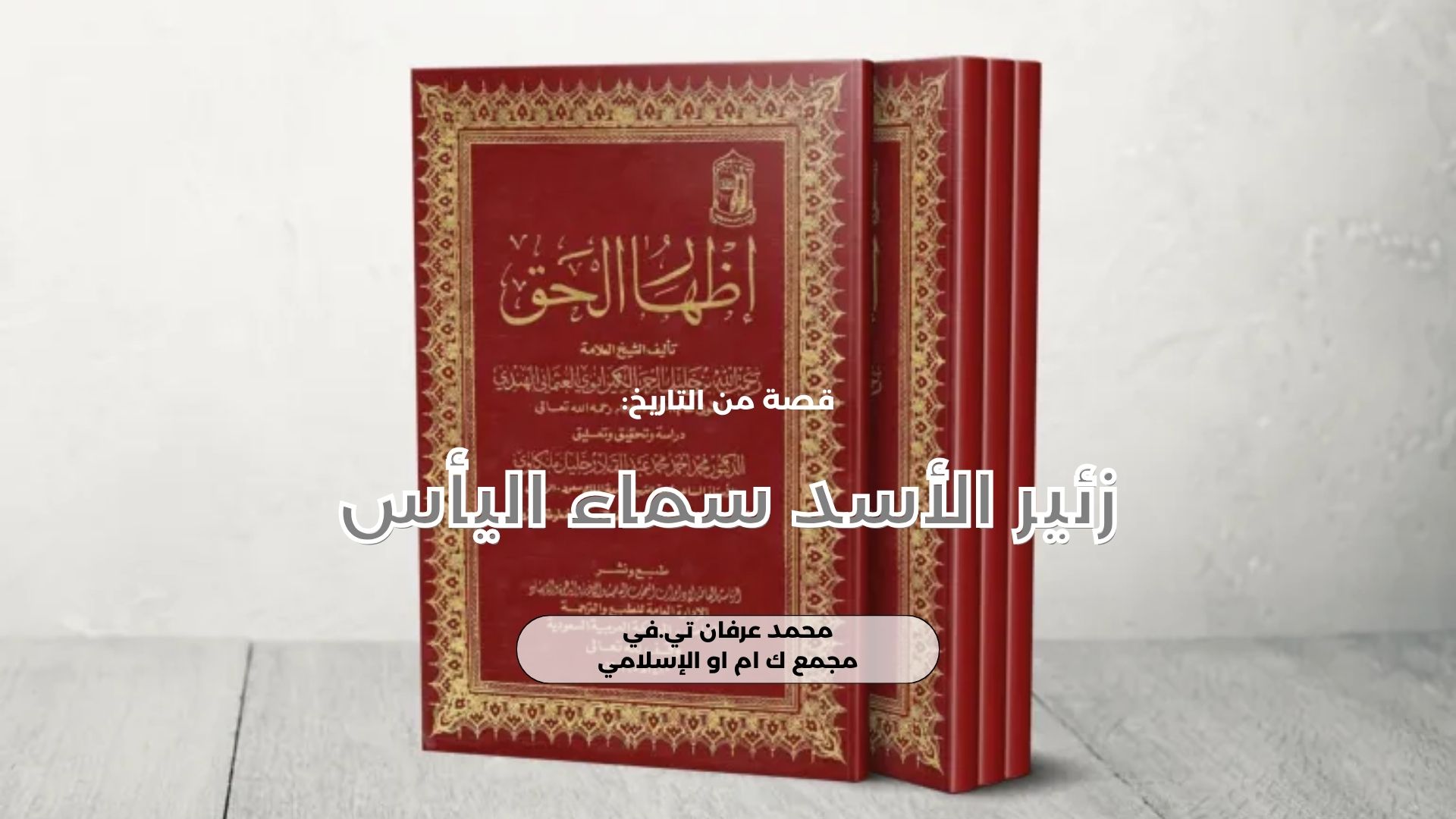المنفى
عبد الرحمن بن حبيب
كان جاك عسكريًا مشهورًا في الأردن. وكان يعيش حياة البذخ والفرح مع عائلته وأصدقائه، ولكن هذا السرور لم يدم إلى الأبد. غير القدر مسيره، حيث نُفي من وطنه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. في الحقيقة، كان جاك بريئًا مما اتُّهم به، وإنما أعداؤه وحساده بسبب سمعته ورفعته جعلوه في قفص الاتهام.
”أيها الشرطيون، هذه المحكمة تقضي بإبعاده إلى تل أبيب في شمال إسرائيل لمدة عشر سنوات، قوموا بذلك فورًا.”
أعلن الحاكم جورج كارنل، لم يكن جاك قادرًا على سماع هذا الحكم الذي يكسر القلوب. لحظة… شعر وكأن الأرض تطوى من تحته. خفق قلبه، وتسارعت أنفاسه، وانهمرت دموعه، ولم يجد ما يقوله…
“سيدي… سيدي… أنا بريء، أنا بريء“
ولكن لم يكن هناك من يسمع كلماته. غادر القاضي المحكمة قاصدًا غرفته، وحينئذ قيّد رجال الشرطة جاك بالأصفاد وأخرجوه إلى سيارة الشرطة.
(بعد مضي يوم في البلد الجديد الذي لاجئ إليه بعد تغريبه…اقرأ الباقي) .
سرعان….ريح شديد هبت من ناحية الغرب أيقظه من نومه “يا رب ماذا وقع لي” مسح جاك عيناه بيده ونظر جيدا يمينا وشمالا لكن ولم يجد هنا أحدا، لا يدري أن قلبه يخفق بشدة من الفزع والخوف… وكان عيناه مليئة بالدموع الحمراء.
بعد مضي يوم في البلد الجديد الذي لجأ إليه بعد نفيه، فجأة… هبّت ريح شديدة من ناحية الغرب أيقظته من نومه.
“يا رب، ماذا حدث لي؟”
مسح جاك عينيه بيده، ونظر جيدًا يمينًا وشمالًا، لكنه لم يجد أحدًا هناك. لم يكن يدري أن قلبه يخفق بشدة من الفزع والخوف… وكانت عيناه مملوءتين بالدموع الحمراء.
أين أمي الحنون… وأبي الرحيم… وزوجتي الحبيبة… وبناتي…؟ وكان ألمه أكبر من أن يُصبر عليه.
قام جاك من مضجعه الذي بات فيه قريبًا من موقف الحافلات. فمسح عينيه بطرف جبته التي كان يرتديها، ومشى قاصدًا أي دكان قريب من الموقف.
وطوال مشيه كان يترنح يمينًا وشمالًا، لأنه كان متعبًا جدًا ولم يأكل شيئًا منذ أن ركب البحر.
وعندما استمر في سيره، رأى جاك دكانًا صغيرًا من بعيد، فأسرع إليه حتى وصل أمامه. (كان يظن أن صاحب الدكان مشغول بأمر ما).
“يا سيدي… أعطني قطعة خبز… أنا جائع منذ أيام… وعطشان…”
قال جاك بصوت خافت، ولم يستطع أن يرفعه، لأنه أصبح ضعيفًا بسبب سفره الطويل.
“اخرج من هنا أيها الشيطان اللاجئ… اخرج!“ ورفع صاحب الدكان يده ليضرب جاك.
فتحرك جاك، وسارت قدماه باحثًا عن دكان أخرى. فحينئذ وقع نظره على لوحة معلقة في زاوية الدكان، وقد كُتب عليها: ‘لا دخول للاجئين’.
فأحزنه ذلك وأثقل قلبه بالغم. وكل من رآه في الطريق عبس وجههم وبصق تجاهه.
ولم يستطع جاك الاستمرار في المشي على هذا الحال البائس، فأراد أن يستريح قليلًا تحت شجرة قريبة منه.
“الساعة الثانية عشرة.” نظر جاك إلى الساعة المنكسرة التي كانت في يده، فامتلأت عيناه بالدموع مرة أخرى…
“أبي، هذه جائزة مني، صنعتها بيدي.”
توقَّد شوق جاك لسماع نداء “أبي”.
هذه الساعة التي أهدتها إليه ابنته في يوم ميلاده، حين بلغ الثلاثين من عمره، أعادت إليه ذكرياتها وزوجته الحبيبة.
وبينما هو جالس، وقع بصره على كوب ظن أنه ماء، تركه أحد الرحالة الذين مروا بهذا الطريق.
نهض جاك واستجمع قوته وجرى نحو الكوب المتروك، ولكن للأسف، عندما وصل إليه، وجده فارغًا.
ولم يستطع جاك الصبر على ذلك، فتمتم قائلًا: “يا رب… ألا تدري أني بريء؟ فلماذا لا تخلصني؟” ثم عاد إلى تحت الشجرة التي كان يجلس تحتها.
وكانت الشمس قد اشتد حرها، إذ لم تهطل الأمطار منذ أيام طويلة.
ولكن شعلة الرجاء ظلت متقدة في قلبه، وكان يؤمن بأن صباح الخير سيأتي.
كثرة الأفكار المزعجة دفعت جاك إلى النوم وهو ناعس، فهبت نسمة من وراء الشجرة… غطّ جاك في نوم عميق، ولم يدرِ أنه نائم. مرت الساعات… وجاك ما زال مستغرقًا في نومه. وفجأة، قبلة على وجهه وصوت نداء:
“أبي… أبي!”
فتح جاك عينيه ببطء، متجاهلًا النداء في البداية، ظنًا منه أنه مجرد حلم. ولكن عندما تكرر النداء، نظر جيدًا، ولم يصدق ما يراه! ابنته الحنونة أمامه، وزوجته الحبيبة!
“يا رب… ما هذا؟ هل أنا ما زلت أحلم؟”
تلاحقت أنفاسه، وانهمرت دموعه، ولم يجد ما يقوله… وما هي إلا لحظات حتى تعانقت الصدور، وامتزجت الدموع بالفرح.
“حبيبي… حبيبتي… لقد استجاب الله دعاءك!”
وأخيرًا، سمح لهم الحاكم بالمجيء إليه. انهمرت دموع الفرح والسرور، ولكن عندما نظرت زوجته إلى جروح جسده، غلبها الحزن، فقد كانت آثار ظلم الناس له، فقط لأنه لاجئ غريب. قالت له بحزن:
“دع عنك همّ الطريق… لا أحتاج إلى شيء بعدكما.”
نهض جاك مستندًا إلى كتف زوجته، ومشى مترنحًا يمينًا وشمالًا، باحثًا عن غابة بعيدة عن عيون الناس. عندها تمتمت زوجته بغيظ:
“الحيوان خير من هؤلاء الظالمين الكافرين!”
لكن جاك لم يكن يسمع شيئًا، فقد كان كالمخمور من شدة الفرح بلقائها. وبينما هو كذلك، وقع بصره على بركة ماء زاخرة…
“دعني يا حبيبتي… أشرب…” ترك يده من يدها وركض مضطربًا نحو الشاطئ، ولكن في أثناء الجري، سقط جاك على سطح الأرض ولم يتمكن من الوصول إلى الماء. فغلق عيناه، ناطقًا: “يا الله… لماذا هذا؟”
“حبيبي… لا تتركنا وحيدين…” صراخ وصياح من الأم وابنتها، ولكن لم يسمع أحد. جلست الأم أمام جثة زوجها، كانت عيناها تفيض بالدموع… “أبي… أبي!” نداء من الابنة الصغيرة، لكن الأب لم يسمع نداءها. “يا للأسف.”
“يا ابنتي، ليس معنا أبوك… إنه تركنا وحيدين… لا بل إنهم قتلوا أبوك! الإنسان أظلم من الحيوانات.”
لم تستطع الزوجة الصبر على هذا الفراق المؤلم، استجمعت قوتها وأخذت ابنتها بيدها، جرت نحو الشاطئ. لم تفكر في شيء، لأنها كرهت أن تعيش في أرض قتل فيها زوجها. لحظة… طرحت نفسها وابنتها في فيضان الماء الشديد، واختفتا في سكون الأرض الطويل… ظهر المساء، وجن الليل، وبعد ذلك طلع الفجر. وفي الصباح، رأى بائع اللبن في طريقه إلى المقهى في زاوية من النهر، جثة الأب وزوجته وابنته، لكن لم يشعر بأي خوف أو قلق، لأنه كان يعرف أن هذه الأمور معتادة في بلده، فاهملهم واستمر في سيره إلى السوق. وفي طريق عودته إلى البيت، لم يجد تلك الجثث الثلاثة. “اليوم حظ سعيد للنسور!” قالها لنفسه وضحك، وعاد إلى بيته، ولم يلتفت إلى الوراء مرة أخرى.